
كل طفل يستحق أن يعيش
الطفولة.
وكل طفولة تستحق
أن يضمها منزل.
كل طفل يستحق
أن يعيش
الطفولة.
وكل طفولة تستحق
أن يضمها منزل .
القادم إلى المنزل هي المبادرة الأولى من نوعها
في المنطقة التي تتطرق إلى فكرة الدعم
والرعاية. وقد وُجِدت هذه المبادرة لأنها تؤمن
بشدة بأنه ليس على الطفل أن يكون من صلبك
لكي ينتمي إلى منزلك.
الفيلم التالي هو عبارة عن قصة تلامس القلوب
عن قدوم طفل إلى منزله الجديد. قصة مشاعر
تجمع بين الشك، والتردد، واليقين، والثقة،
والحب الذي يفوق كل تلك المشاعر. إنها رحلة
عاطفية تدور حول طفل واحد يمتلك من القوة ما
يكفي لتغيير حياة ملايين الأطفال.
يرجى التمرير للبدء

ولكن قبل أن تبدأ في أي رحلة، عليك أولاً أن تنتهي من إعداد نفسك لها. يوضح لك هذا القسم الفكرة بشكل كاف ويقدم لك الدعم المعنوي الذي سيساعدك على دعم أو رعاية الطفل.












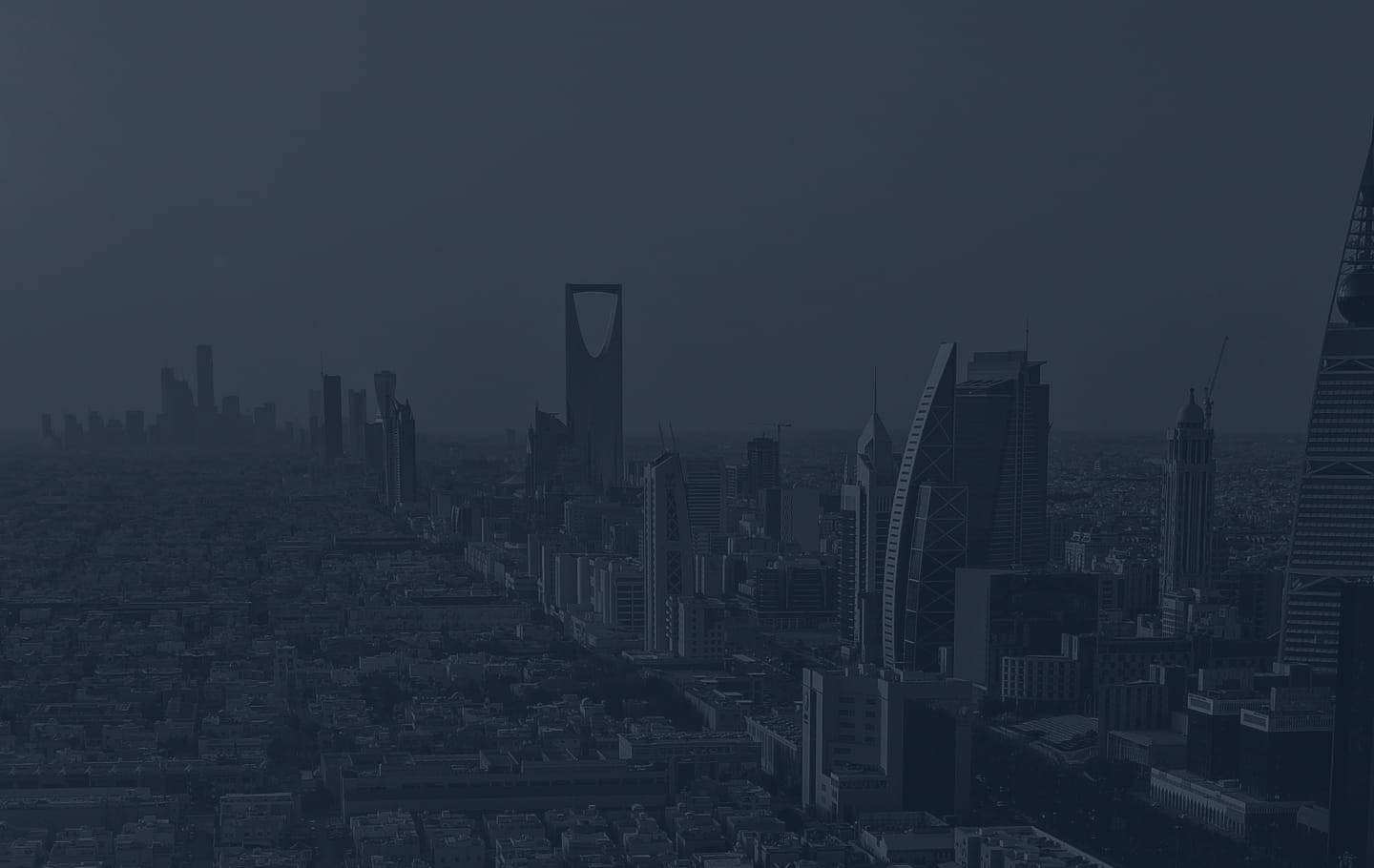





تواصل مع مركز
يقال بأنه لا وجود لطفل لا يرغب به أحد، وإنما في الحقيقة يوجد عائلة لم تُكتشف بعد. إذا كنتم راغبين بأن تكون منازلكم وقلوبكم سكناً لطفل، فإليكم بعض أسماء المؤسسات للتواصل معها ومعرفة المزيد حول رحلة الدعم والرعاية.
بالقادم إلى المنزل


حلم تحقق (أم رزق)
أعرّفكم بنفسي، اسمي دينا طارق، وعمري 33 عاماً، عازبة، مواطنة مصرية. ابني اسمه رزق وأنا كما ينادونني بالعربية "أم رزق". أنا واثقة من أن قصتي واحدة من أطول قصص التبني والحضانة، فقد انتظرت ولدي لمدة 11 سنة، إلى أن أصبحت أخيراً أمه رسمياً منذ فترة قصيرة. وسنجعل من هذا اليوم يوماً مميزاً باعتباره عيد مولده الثاني (23.1.2023).
التقيت رزق في دار للأيتام عندما كان عمره لا يتجاوز السنتين ولم يكن في نيتي يومها أن أتبناه. فقد كان التبني متاحاً بموجب القانون حصرياً للأزواج. لم أعد إلى الدار ولم أكن أفكّر أساساً في العودة إليها، لكن مشيئة الله كانت غير ذلك. فقد اختارني ولدي، نعم، اختارني وفقاً لأجمل خطة ممكنة. كنت عائدة ذات يوم من دوام عملي ورأينا بعضنا صدفة، فعرفني حتى بعد مرور ثلاثة أسابيع من زيارتي. شعرت كأن قلبي يقفز من مكانه عندما رأيت ابتسامته ويده الصغيرة تلوح لي. ذهبت على الفور لزيارته في اليوم التالي وسألت مسؤولي دار الأيتام إذا كان بإمكاني أن أهتم به، فوافقوا. ولأول مرة، شعرت بأحاسيس الأمومة وعرفت معناها. شعرت بأن رزق هو ابني، بأن بيننا رابطاً عجيباً وغامضاً لا أستطيع وصفه. شعرت بأنني أم يعيش ولدها بعيداً عنها.
لم تكن رحلتنا سهلة بتاتاً. كان رزق يعيش في دار الأيتام وكنت أتركه كل يوم لأعود إليه في اليوم التالي. لم يكن ذلك بالأمر السيئ، لكن الواقع أن الحياة في دار للأيتام ليست ما يستحقه الأطفال. طفلي أو أي طفل يستحق أني يكون له منزل، يستحق الحب، والأمان، والسكينة.
مضت الأعوام وبدأ رزق يدرك وضعه غير المثالي، ويتمنى حياة يشعر فيها بالاستقرار. كنت أصلّي طوال أحد عشر عاماً وأطلب أن يكون لابني بيت، ويحيط به أشخاص يمنحونه الحب والمعنى الحقيقي للعائلة.
تقدّمت بطلب لتبني رزق بعدما سمح القانون بذلك للنساء العازبات. ثم توالت العقبات، فقد رُفض طلبي مرتين بسبب ظروف الوضع غير المألوفة. كيف ستتبنى امرأة بعمر الثالثة والثلاثين ولداً بعمر الثانية عشرة؟ تقدمت أكثر من مرة مع شرح لقصتي مع ولدي ولإقناعهم بأني مثل أمه، وكيف بقيت بجانبه ولم أبتعد عنه طوال 11 عاماً.
الآن، رزق هو النعمة والبركة في حياتي، هو كنزي، مكافحي الصغير الذي يعيش معي، وكل عائلتي تحبه وترحّب به كونه الفرد الأصغر في بيننا.
أتمنى أن يفكر الناس في تبني الأطفال الكبار أيضاً لأن كل الأطفال يستحقون عائلة محبة تحضنهم وترعاهم.

عندما جمعنا القدَر
على عكس الكثير من الأمهات، لم يحصل حملي في رحمي، بل في قلبي.
عندما بدأت إجراءات التبني كنت أشعر دائماً بالشوق لرؤية الطفل، كنت أودّ أن أعرف من يكون وكيف يبدو، كيف يضحك وما هو لون عينيه، وكيف هو شعره.
كنت أشاهد صور أطفال كثيرين وأتساءل إن كان طفلي سيكون شبه أي منهم، فأنا أعشق الأطفال وأدرك أنهم نعمة ثمينة. كنت أقدّر قيمتهم حتّى قبل أن أعلم أني سأصادف عثرات في الحمل والولادة بعد الزواج.
حين بدأت الإجراءات قلت لنفسي إني سأحبّ الطفل كيفما يكن لأني أحب الأطفال بشكل عام. أشخاص كثيرون محبطون وغير قادرين على الاستيعاب قالوا لي إن الولادة من صلبي ستمنحني إحساسًا مختلفاً لكن هذا الكلام لم يخفني ولم يحبط شيئاً من عزيمتي. كنت قد قمت بعمليتين للحقن المجهري، وفي الأصل لم أكن قد سمعت بما يسمى كفالة الأطفال أو أي شيء من هذا النوع.
كانت صديقتي الحبيبة نسمة أول من أطلعني على الأمر. رفض زوجي الفكرة في البداية، ولكن عندما أخبرته عن قصص العديد من الأسر اقتنع، لا بل اقتنع جداً وقال لي: "نحن ماذا نريد؟ نرغب في أن يكون عندنا طفلة أو طفل نكون له أماً وأباً، ويكون هو ابننا". سألته عن الفرق بين أن يكبر الطفل داخل بطني أو بيننا ومعنا ويكبر حبه في قلبنا، فطمأنني وقال لي إنه لا يوجد أي فرق بالنسبة إليه.
أنهيت الإجراءات وانطلقت في زيارة دور رعاية الأطفال وسألت هناك إن كان لديهم طفلات بنات، فقالوا لا. أروني الأطفال الذكور الرضع وكان حمزة أول طفل حملته، بعمر الشهرين وأسبوع. ضحك لي ضحكة جميلة جداً وراح ينظر إلي بعينين تكادان تنطقان كأنما يقول لي: "أنت ماما!" بدا مستغرباً كأنه لا يصدق أنه أخيراً وجدني، والحقيقة أني أنا التي لم أكن أصدق أني وجدته. حضنته بين ذارعي وأنا أبكي طبعاً من فرح كبير لا يسعه قلبي. عندما أنزلته عن كتفي وجدته يغط في النوم، شعرت بأنه ارتاح وأحس معي بالأمان.
ومن تلك اللحظة وأنا أذهب إليه يومياً في الدار. أما حبي له فيكبر باستمرار بشكل لم أكن أتوقعه. مهما وصفت لكم شعوري وحبي لحمزة قبل أن أراه وبعد أن رأيته فأنا لن أكتفي. وأساساً لا أذكر حتى كيف كنت أحبه قبل أن أراه.

بداية أجمل حكاية
مثل كل أم اختارت التبني، يسألني الجميع كيف وردت هذه الفكرة في ذهني وكيف جرؤت على تنفيذها. في الواقع، مثل كل أم قامت بالتبني كانت الفكرة تراودني دائماً، ولكن في حالتي بدأ الحلم منذ سن المراهقة. بالنسبة إلي كان الأمر يحمل الكثير من المنطق. لمَ أفكر في جلب طفل آخر إلى عالمنا، في حين أن هناك الكثير من الأطفال الذين ليس لديهم من يقف بجانبهم ويعتني بهم. حينها تيقنت من فكرة سيطرت على وجداني، أنني عندما أصل إلى المرحلة التي أكون فيها مستعدة لأكون أماً وجاهزة عاطفياً ومالياً، لن أتردد في أن أتبنى طفلاً. وهذا الحلم الجميل تحقق بالفعل.
حينها كان لدي أنا وزوجي ابن أنجبناه وهو سليمان الذي كان عمره نحو 3 سنوات. بدأت النصائح المعهودة في مجتمعاتنا تنهال علينا أن نأتي له بأخ أو أخت. وعندما كان سليمان على وشك إتمام أربع سنوات، شعرت أنا وزوجي ياسين بالاستعداد لاستقبال طفل آخر. وها قد أتت فرصتي. تحدثت مع زوجي وأخبرته عن حلمي في ضم طفل إلى أسرتنا عن طريق التبني. لم أرغب في أن تكون موافقته من باب إسعادي فقط، كما يفعل دائماً، ولكن أحببت أن يكون قراره نابعاً من قلبه مثلي تماماً. أخذ ياسين نفساً عميقاً وسألني "هل أنتِ متأكدة؟". أجبته بكل ثقة نعم بالطبع، ولكنني أردت سماع رأيه بكل صراحة. أجاب على الفور "لا بأس، هيا بنا".
في أول دار للأيتام قمنا بزيارتها. كان سيف أول طفل رأيناه، وفي غضون ثوان سمعت ياسين يقول "حسم الأمر، هذا هو ابني". بعد مرور 5 دقائق فقط وفي الوقت الذي كان زوجي يلاعب سيف ويتودّد إليه، كان ذلك الشعور نفسه الذي لمس قلبي. ومن هنا بدأت أجمل حكاية.

قدري أن أكون أماً
منذ طفولتي وأنا أحلم بأن يكون لدي الكثير من الأطفال. وبشكل خاص، كنت أرغب بأن تكون لي طفلة أنثى، ولذلك أخذت مع مرور السنين أشتري دائماً ملابس الطفلة التي سأنجبها يوماً ما.
تزوّجت في سن مبكرة جداً، في عقد العشرينيات من عمري، حين انتقلنا أنا وزوجي إلى سان فرنسيسكو. ثم اكتشفت أني مصابة بالتهاب بطانة الرحم. وبسببه أصبح احتمال حملي ضئيلاً جداً. حاولت ألّا أفقد الأمل وخلال أحد عشر عاماً، ضعت في دوامة عمليات الإخصاب في المختبر (الأنبوب)، بلا جدوى. أتعبتني تلك الفترة من حياتي، مادياً وعاطفياً، وأدّت بي إلى الطلاق عام 2004.
رجعت إلى مصر، وأردت الابتعاد عن موضوع الأطفال، لكني أعتقد أنّه كان للقدر رأي مختلف. عام 2012، التقيت زوجي الحالي وتزوّجنا. وعلى الرغم من أنه كان والداً لابنتين، كان يعرف بحلمي أن أصبح أماً فعرّفني على برنامج "كفالة". كان دعمه يعني الكثير بالنسبة إلي. استغرق تحضير الوثائق والإجراءات عاماً كاملاً قبل حصولنا أخيراً على إمكانية احتضان طفل.
استبد بي الخوف والقلق، ورحت أسأل نفسي، "هل أنا مستعدة؟ هل سأقدر على تربية طفل واللعب معه وأنا بعمر الخامسة والأربعين؟ هل كان من الأفضل أن أبقى على حالي وأواصل حلمي بأن أصبح أماً؟" في النهاية، كانت الغلبة لتشجيع زوجي ورغبتي العميقة في أن أكون أماً.
هكذا بدأت أبحث عن ابنتي وأملي أن أجد طفلة جميلة داكنة البشرة تشبهني أنا وزوجي. خلال زياراتي لدار الأيتام "فايس" في منطقة المعادي، كنت أقصد فقط دور الطفلات الإناث. رأيت الكثير من الطفلات الرائعات اللواتي يستحققن كل الحب، لكن لم أشعر بقلبي يخفق خلال تلك الزيارات. اعتقدت أنّه ربما وحدها الأم المنجبة تشعر بهذا الرابط. وبعد ذلك اخترت طفلة لطيفة تشبهنا، حتى ولو أن قلبي بقي بدون أن يهتف، وبدأتُ المعاملات.
ذات يوم، سمعت عن طفلين حديثي الولادة وصلا إلى الدار، بنت وولد. ذهبت لأرى الطفلة، في محاولة أخيرة لأرى إذا كنت سأشعر برابط عاطفي بها. كانت طفلة رائعة لكن بدون أي شبه بنا، شقراء بعينين زرقاوين. أطبق على صدري وفقدت الأمل بأن أحس بشعور الأم السحري الذي أسمع عنه. أدرت رأسي بغير انتباه فوقع نظري على المولود الآخر، الولد. فوجئت عندها بعينيه الواسعتين وهما تنظران إلي بإمعان. قفز قلبي من صدري وانتابني شعور غريب في حلقي. عرفت على الفور… هذا ولدي. لم أبتعد عنه، حملته، أطعمته، غيّرت له ثيابه. كنت خائفة أن يأخذه والدان آخران، فأصررت على دار الأيتام حتى غيّروا معاملاتنا واستبدلوها بوضع اسمه.
لم أتوقع يوماً أن حلمي بإنجاب الأطفال سيتحقق، أو أنه سيتحقق بهذا الطريقة. اليوم، لدي ابنتان من زوجي، وابن لم أتصور أن يكون ابني. ليست الكفالة التزاماً سهلاً لكنها تستحق المحاولة. كل مساء، أخبر ابني قصته الحقيقية ليعرف دائماً من هو ومقدار الحب الكبير الذي يستحقه. وكل ما أتمناه أن يجد كل الأطفال بيتاً يحميهم وعائلة تحضنهم.

رحلة طفلتي إلى منزلها
بدأت قصتي منذ ما يقارب 25 سنة عندما كنت في الثانوية العامة. أخذتنا المعلمة لزيارة دار للأيتام فصُدمت برؤية ذلك العدد الكبير من الأطفال المحرومين من عائلة أو من منزل. وعرفت حتى منذ كنت في الخامسة عشرة أني ذات يوم سأساعد على الأقل واحداً من أولئك الأطفال.
حلمت بأنني سأتبنّى طفلاً بعد أن أتزوج وأنجب طفلي الأول لأتمكن من إرضاعهما معاً. لكن لم يكن مقدّراً لذلك الحلم أن يتحقق، فأنا الآن في سنّ الأربعين وما أزال عازبة، لكني كنت قوية، فخورة، سعيدة، ورفضت الاستسلام.
انتظرت اليوم الذي سيتاح لي فيه أن أتبنى طفلة أمنحها فرصة أن يكون لها حياة طبيعية. الحياة الطبيعية التي حُرمَت منها منذ أن فتحت عينيها على الدنيا وتُركت وحيدة تربّيها "أمهات" حاضنات، موظفات لرعايتها. "أمهات" يأخذن إجازات شهرية منظمة بغض النظر عن مشاعرها، وصحتها، واحتياجاتها التربوية أو التعليمية أو غير ذلك من احتياجات الأطفال. "أمهات" ربما يغادرن المركز ليتزوجن فتحل مكانهن موظفات أخريات. أي طفولة هذه؟ وأي إنسان سينشأ نتيجة لها؟ لأن كل طفل يستحق عائلة تحبه وبيتاً يحضنه ❤.
حدث ذلك في شهر مارس 2020 عندما عرفت بالتعديل الذي حصل في القوانين والأحكام. وفي يونيو 2020، وجدت رابطاً إلكترونياً لتقديم الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي. فتقدمت. ضممت كل الوثائق المطلوبة ونتائج الفحوصات المخبرية، ففُتح ملف خاص بي. تم تعيين مساعدة اجتماعية لمتابعة ملفي، وزيارتي وتدوين الملاحظات. طلبت منها أن تسرع بتقريرها عني لأن الاجتماع الأخير للجنة كان على وشك الانعقاد. كنت في أشد حالات القلق.
لكن حصل أكثر ما كنت أخشاه. فقد عرف والدي وعلى الفور قال: "لا". لم يكن مقتنعاً بقراري. كان قلقاً بشأن المسؤوليات التي يستتبعها هذا القرار، وكيف قد يؤثر في صحتي، ويضطرني إلى تغيير نمط حياتي. لم يستطع أن يفهم كيف اخترت بنفسي أن أصبح أماً عازبة. لكني كنت عنيدة. وبعد إصراري تحوّلت "لا" إلى "لنرَ".
في الأسابيع التي تلت، رأيت أكثر من سبعة أطفال، من الشهرين ونصف إلى الأربعة عشر شهراً من العمر. رأيت أطفالاً إناثاً وذكوراً، لكني عرفت أن طفلي لم يكن معهم. لم يخطر لي حتى أنها لم تكن في القاهرة!
ثمّ ذات يوم، وجدت من أطلعني على صورة لأجمل طفلة رأيتها في حياتي، عمرها بالضبط 27 يوماً. كانت عيناها البريئتان كأنهما تنظران مباشرة إلى داخل روحي. خفق قلبي لمجرد رؤيتها!
أسرعت إلى منطقة السويس حيث التقيت أخيراً بابنتي. فأهلاً بك في بيتك يا صغيرتي غالية.

اكتشفت مع الأمومة طاقة لم أكن أعرف أني أملكها
كانت رحلتي نحو الأمومة عبارة عن سلسلة من المحطات، وكان عليّ أن أجد في كل منها مخزوناً جديداً من القوة، القوة للاستمرار، القوة للحفاظ على الثقة، القوة لمواصلة الأمل.
جرّبت عمليات الإخصاب مرة بعد مرة، ولكن انتهت جميعها بالإخفاق. لم أنل منها غير صدمات مؤلمة وقلب محطم. ثمّ لاح لي بريق من الأمل عبر منشور على فيسبوك يتكلم عن التبني. اتصلت بالأم التي شاركت بكل فرح قصة تبنيها فوصلتني مع الجهات الصحيحة. ووجدت عندها الطاقة لأخوض درباً جديدة نحو الأمومة من خلال التبني.
انطلقت عندئذٍ مع زوجي داني في رحلة للتبني دامت عامين كاملين. بعد قوانين التبني المتغيرة، وسلسلة من المعاملات والوثائق المطلوبة، والزيارات المنزلية، والوثائق التي ضاعت، وزيارات التحقق، وطلبات الموافقة، واستسلامنا لليأس، ثم التنقيب بحثاً عن قوة جديدة، حصلنا أخيراً على الموافقة. هكذا بدأنا البحث عن الطفل الذي يناسبنا ونناسبه، ويجعل مني أماً. في غضون ذلك، فقدت والدتي لإصابتها بمرض السرطان وبعدها بشهور قليلة توفّيت والدة زوجي أيضاً. كانت فترة مؤلمة وعصيبة… إلى أن تلقيت اتصالاً حمل إلي الأمل.
علمت من خلال ذلك الاتصال بوجود طفلة بعمر الشهرين للتبني. كنا نفكّر بتبني طفل أكبر قليلاً، بعمر الستة أشهر تقريباً لأنّ فكرة الاهتمام بطفل حديث الولادة كانت تُوتّرنا بعض الشيء. ولكن من نظرة واحدة إليها، عرفت كيف أجد القوة لأكون أماً. وبعد أشهر أخرى من الأخذ والرد، أصبحنا أخيراً عائلة واحدة من 3 أشخاص، وأسمينا ابنتنا زين.
أنا اليوم بعمر السادسة والأربعين وأم لطفلة صغيرة. بعد 13 عاماً من المحاولات، ها أنا أخيراً أحملها بين ذراعيّ. كانت رحلة طويلة لكل خطوة منها مصاعبها. لكن رحلة أمومتي الحقيقية في بدايتها وأنا أنتظر بفارغ الصبر أن أستمتع بكل تجربة جديدة تحملها بدورها إلي.

اخترت أن أكون أماً
أنا الدكتورة عائشة البوسميط، إعلامية وكاتبة من دولة الإمارات، وأم حاضنة لأميرتين رائعتين بعمر الثالثة عشرة والسبع سنوات. قصتي تتحدث عن تجربتي مع الاحتضان، وكيف أصبحت هذه التجربة ملهمة للعديد من الأسر.
الاحتضان ليس أمراً جديداً في مجتمعنا، فهناك الكثير من العائلات المحتضنة، ولكن الحديث عنها يبقى شيئاً جديداً وملفتاً. يتطلب اتخاذ قرار الاحتضان شجاعة ووعياً، فكثيراً ما يتم التراجع عن هذا القرار بسبب الخوف من رد فعل المجتمع وعدم دعم الأهل والأصدقاء. ومع ذلك، يتضح أن الدعم يأتي لاحقاً من الأشخاص أنفسهم بعد إقدامنا على التجربة، إذ يشعرون بالفرح والسعادة عندما يرون النتائج الإيجابية التي يجلبها الاحتضان إلى حياتنا.
يعتبر اختيار الطفل المناسب الذي تشعرون بأنكم قادرون على تربيته ورعايته بمحبة وسعادة رحلة مهمة للغاية، فتفاصيل الحياة تتغير بعد الاحتضان، ويصبح الطفل المحتضن محور العائلة والمصدر الأساسي للمحبة والرعاية، فيملأ الحياة بالسعادة والبركة. وقد أثبتت لي تجربتي مع الاحتضان أنه قادر على تغيير حياتنا، فبعدما احتضنت ابنتي الكبرى بعمر الثلاث سنوات وابنتي الأخرى بالعمر نفسه، أدركت أهمية التجربة الجميلة في حياة عائلتي. واليوم، يوافق جميع من حولنا على أن الاحتضان يجلب السعادة والهدوء للأسرة.
من اللحظة التي سمعت فيها صوت طفلتي الأولى، شعرت بأنه صوت من الجنة، دخل قلبي قبل أن أراها. وعندما دخلت الغرفة وابتسمت عند أول لقاء لنا، تأكدت من أنها الطفلة التي كنت أبحث عنها.
بعد فترة من هذه الرحلة الأولى والرائعة، بدأت ابنتي تلح علي لاحتضان أختٍ لها. لم أعر الأمر اهتماماً في البداية، لكنها لم تتوقف عن السؤال: "أين أختي؟ لماذا تأخرت؟". فشعرت بأن رغبتها ملحة في وجود أختٍ لها، واقتنعت بأنها ستكبر وستكون بحاجة لأخت تكبر معها وتشاركها أفراحها وأحزانها.
بدأت رحلة الاحتضان الثانية، ولم تكن الأمور واضحة بالنسبة إلى السماح لنا باحتضان طفل آخر، لكن إيماني بأنني سأحظى بهذه الفرصة مرة أخرى كان قوياً. هكذا تقدمت بطلب احتضان طفلة من جديد، وخضت تجربة البحث التي تعد من أصعب المراحل على الأسرة المحتضنة. وبعد طول انتظار عثرت عليها، وهي الآن بعمر السبع سنوات تملأ البيت مرحاً وسعادة.
تعد المصارحة في الاحتضان من الخطوات الأساسية التي تضمن بناء علاقة صحية ومستدامة. لذا تجاوزت تخوّفي، وصارحتهما بالواقع، وأدركت أن هذه الخطوة هي البوابة إلى الحب والسعادة.
لا شك في أن رحلتي مع الاحتضان كانت مليئة بالتحديات، لكنني تغلبت عليها. والآن لا يوجد شيء يسعدني أكثر من أن يتم احتضان طفل، وأن يظل هذا الطفل في بيت سعيد ومليء بالبركة والسعادة.
















